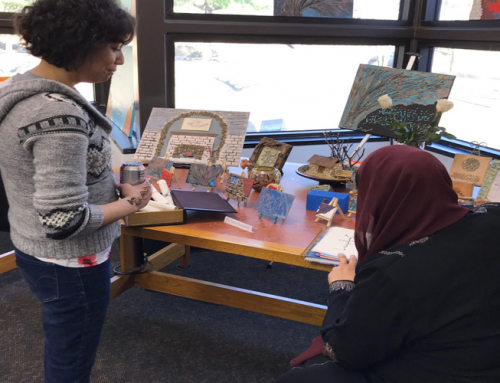المقدمة : تتلخص رؤية المؤلف في أن إشكالية مفهوم مصطلح الإرهاب منذ حدث 11 سبتمبر 2001 ميلادي، أصبحت هلامية وغير واضحة، وأصبح لزاماً على الأمة الإسلامية ممثلة في كل مؤتمراتها وكل منظماتها بذل مزيد من الجهد لتوضيح المفهوم للمجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي بكل ثقافاته وعقائده، الذي يفتقد لتعريف عالمي موحد يتوافق عليه الجميع.
حيث أن جل المفاهيم المتداولة إعلامياً قد حمًلت مصطلح “الإرهاب” أكثر مما يحتمل معناه وتخطت إشكالية المفهوم، الحدود الدينية والثقافية والسياسية إلى الحدود الوطنية والقومية والعقائدية، حتى تم إلحاق صفة الإرهاب بالإسلام (اسلاموفوبيا). الأمر الذي يجعل من قضية المفاهيم قضية مركزية، يجب إستثارة مكنوناتها ومساءلتها حتى لا يتم تكييف اللفظ ليستوعب المصالح السياسية والاقتصادية وتغيراتها فيثير أبعاداً دينية عقائدية للأحداث.
وقد ورد عنوان الكتاب تحت كلمة “إشكالية” وليس “مشكلة” حيث استند المؤلف على قول جورج طرابيشي[1] للتفريق بين اللفظين حيث يقر بأن الإجابة على الإشكالية أكثر تعقيدا من الإجابة على المشكلة وتكتنفها جملة صعوبات وقابلة لأجوبة متعددة بل متناقضة.
تعريف الإرهاب لغة واصطلاحاً: كلمة إرهاب مأخوذة من رهب بكسر الهاء، يُرهب رهباً، وهو بمعنى الخوف مع تحرز واضطراب. وتعادلها بالإنجليزية كلمة (terror) وهي الأكثر شيوعاً وأصلها لاتيني (terr) وتعني الترويع أو الرعب. وكلمة (Terrorism) تقابلها إرهاب بكسر الهمزة بمعنى الإزعاج والإخافة. وفي الغرب معني (Terrorism) مأخوذ من الفارسية وتعني الإرهاب، واشتقت الفارسية الحديثة مصطلح (ترساندن) من ذات المعنى وتعني التخويف أو خلق الرعب.
وفي الأدب الفكري هناك العديد من الآراء والتعريفات لمعنى الإرهاب، ولكن لا يوجد حتى الآن إتفاق دولي وعالمي موحد على التعريف لوجود خلاف في تحديد معناه وحدوده، فما يراه البعض إرهاباً يراه غيرهم نضالاً مشروعاً. وهذا الكتاب يورد ثلاث اتجاهات سلكها الباحثون لتعريف الإرهاب، الاتجاه الأول يستبعد ايجاد تعريف جامع لعجز المجتمع الدولي عن التوصل لما يقبله الجميع، والاتجاه الثاتي يرى إمكانية التعريف من خلال الأفعال المادية دن النظر إلى مرتكبيها ودوافعهم التي قد تكون مشروعة، أما الاتجاه الثالث فيقوم على الدراسة العلمية والموضوعية ويأخذ في الاعتبار أهداف ودوافع الإرهاب بغض النظر عن أساليب التنفيذ، وهذا الاتجاه هو الذي سلكته العديد من المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والعالمية مثل تعريف مؤتمر توحيد القانون الجزائي 1937م، وتعريف عصبة الأمم المتحدة 1937م، وتعريف دول عدم الإنحياز 1984م، وتعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعريف معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 1994م …الخ.
أما عن مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم فقد وردت كلمة الرهبة بمعنى الخوف والإخافة، فمن رهب وخاف الله كان من المتقين وله الثواب في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن التقوى فقد وقع تحت عقاب الله. وجاءت في ترهيب المسلمين لعدوهم وعدو الله ورسوله وتحريضهم على ذلك ، لقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) [2]وجاءت في ترهيب المشركين أيضاً لقوله تعالى: (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)[3] . لذلك فالعنف والإرهاب الوارد في الإسلام هو عقاب مقصود من الله سبحانه وتعالى لإصلاح الذين عصوا وانحرفوا وأشركو واستهزأو برسله، فهو للإصلاح والتذكير بأن الله قوي عزيز قادر على كل شئ، وجاءت الرهبة مقابلة ومناظرة للجزاء والثواب والرحمة التي وعد الله بها المؤمنين.
ويحدد المؤلف ثلاث أنواع للإرهاب هي: الإرهاب المعلوماتي، مثل مايتم في وسائل الاتصال من نشر للأفكار المضللة التي تنافي الأخلاق والفطرة السليمة. والثاني الإرهاب الفكري: وهو الأخطر لأنه ينفي الآخر ويكمم أفواه من يطلق حرية الفكر والرأي ويعرضه للاضطهاد والقتل. والثالث الإرهاب التاريخي أو الحضاري، وهو ما يروج له اليوم بصراع الحضارات لإلغاء بعض الحضارات وتصويرها كامتداد لحضارات قديمة، ويدخل في هذا النوع استخدام مسالة الهولوكوست وتضخيمها لابتزاز الدول والشعوب وتجاهل المآسي والمذابح والتصفيات التي تتعرض لها الشعوب الأخرى.
ولتقريب الفهم يورد مؤلف الكتاب فروقاً بين الإرهاب وبعض الأعمال المشابهة له مثل الفرق بين: الإرهاب والحرب، الإرهاب وحرب العصابات، الإرهاب والجريمة المنظمة، وأخيرا الفرق بين الإرهاب وحركات التحرر. والخلاصة بروز رأيان حول المقارنة بين الإرهاب وتلك الأنشطة السياسية. الرأي الأول يرى أنه ينبغي التمييز بين الإرهاب وتلك الأنشطة التي تمارسها حركات سياسية ثورية مغلوبة على أمرها وهذا رأي كثير من فقها القانون الدولي ما دام أعضاء تلك الحركات وبشكل خاص حركات التحرر يُخضعون أنفسهم للقانون. أما الرأي الثاني فيرى عدم التمييز بين الإرهاب وتلك الأنشطة وهذا هو السائد في الغرب حالياً. وهذا الخلاف قائم وواضح بين دول العالم الثالث والدول الغربية حول شرعية الكفاح المسلح الذي نصت عليه مواثيق وقرارات الأمم المتحدة، ولهذا فإن إشكالية مفهوم الإرهاب تظل قائمة وتضعنا أمام تعقيدات يصعب معالجتها من منظور فكري مفاهيمي، حيث لا اتفاق بين الغرب والشرق حول بعض المعاني التي تشكل القاموس الأخلاقي لكلٍ منهما، فإن اتفق الأمريكان وأهل الشرق على خطأ قتل حياة إنسان برئ، إلا أنهما لا يتفقان على من هو البرئ؟ مما يحيلنا إلى افترق في المفاهيم أشد تعقيدا من فكرة صراع الحضارات أو العداء للإسلام.
أيضا هناك إشكاليات حول إدراك المفهوم وتبريرات الممارسات السياسية : ينطبق ذلك خصوصاً فيما يتعلق بثنائية الإسلام والغرب. وهذه ثنائية مغلوطة في الأصل، إذ لا يجوز المقارنة إلا بين أصول متشابهة، مثل الإسلام والمسيحية، أو بين الشرق والغرب. فالاستمرار في المقارنة بين الإسلام والغرب يخلق إسقاطات غير منطقية ومقارنة خاطئة بين فكر مجرد وبين نطاق جغرافي مر بسياق تاريخي وضم تطورات فكرية واجتماعية وسياسية مهدت لقفزة حضارية غير مسبوقة. هذا الخلط لا ينفي وجود سياسات معينة بررت وجوده، فالسياسة الأمريكية مثلاً لا تفرق بين الإسلام والمسلمين عملياً؛ لأن المنطق السياسي غير معني كثيراً بالناحية التجريدية المعرفية، وإنما معْنِي بما هو عملي ومصلحي[4] . أما 11 سبتمبر 2001 م كتاريخ شهد حدثاً عالميا فقد تنوعت تفسيراته من الديني والسياسي، إلى الحضاري، والثقافي، والنفسي، والبنائي، لكن يبدو أن الملمح الثقافي ـ الديني طاغيا في تحليل الحدث ورمزيته على الأقل في الرؤية الغربية الأمريكية تحديدا فتحدثوا عن الفاشية الإسلامية، والإرهاب الإسلامي، والأصولية الإسلامية، مرورا بالسؤال الأمريكي العريض: لماذا يكرهوننا؟ وانتهى بممارسات أمريكية حول نشر الديمقراطية في البلدان الإسلامية، وتأهيل المسلمين ليكونوا ديمقراطيين، وتغيير مناهج التعليم لنشر ثقافة التسامح. ساد المنظور الثقافي في ظل العولمة وظهر حديث عن “صراع الحضارات” وفي ظل تشدد وممارسات “تنظيم القاعدة” وخطابها الديني ـ السياسي، المشبع بالعنف ضد الكفرة من اليهود والصليبين، حول الإسلام إلى مشكلة عالمية وقد راق ذلك للقاعدة بأن صورت محاربة الغرب لها محاربة للإسلام، وهذا اختطاف للإسلام، لأنها ليست ممثل الإسلام الوحيد وما طرحته فكرياً ليس من الإسلام في شئ. تشابه خطاب القاعدة والخطاب الرسمي الأمريكي حيث ركزو على ثنائيات حدية (إيمان/كفر) ، (خير/شر) ، و (معنا/ضدنا) فانعش ذلك المخيلة الغربية المشبعة بفوبيا “التهديد الإسلامي” الذي يعود لأزمنة وسيطة. كل هذا يحدث في ظل فراغ وإنقسام عربي اسلامي مستمر منذ عشرة قرون يشير إلى غياب هوية متفق عليها. كما أن “الحرب على الإرهاب” في ظل فضاءات متعددة سياسية ودينية وثقافية جعلها تتسع على نطاق العالم، ورافق هذه الحرب أحوال إنسانية، وصراعات سياسية، وضرورات بترولية، ولوازم انتخابية، وقفت كلها وراء السياسة الأمريكية وحربها، ولا زالت تمدها بالمبرر والدافع.
والواقع أن الإشكالية ليست محاربة الإرهاب، بل استخدام المفهوم لمحاولة إصلاح العالم العربي الإسلامي بما يتوافق مع الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية، وهو ليس إصلاحا حقيقياً وإنما انتهازيا ليصبح كفاحا من أجل الحداثة والعلمانية والقيم الغربية. والإصلاح الديني من المنظور الغربي يتلخص في تحديث الإسلام، وذلك لحل مشكلة “الإسلاموفوبيا”. لكن المشهد السياسي يرينا بوضوح انتهازية استخدام المصطلح لتحقيق الإصلاح السياسي وفق معادلة جديدة تحجم عن دعم الانظمة الاستبدادية وتدعم الديمقراطية، ولكن عند بروز أحزاب اسلامية نتيجة الانتخابات الديمقراطية في بعض دول الشرق الأوسط يتراجع دعم الديمقراطية لصالح الاستقرار وتأمين المصالح. والإصلاح من وجهة النظر الأمريكية يرى ضرورة فتح قنوات حوار مع التيارات الإسلامية المعتدلة لإنشاء إسلام (ليبرالي) يتم فيه فصل الدين عن الدولة، ويتقبل الديمقراطية، وحقوق النساء والأقليات، وقبول الآخر. وفي المقابل برز ما سمى “تجديد الخطاب الديني” غير أن هذا المفهوم هلامي لا يتعدى معناه اللغوي البسيط الذي يعنى التغيير. والإشكالية أن مفهوم تجديد الخطاب الديني قد تصدى له الكل، منهم الداعية، والموظف في مؤسسة دينية رسمية، والحداثيون الذين سعوا لاضعاف المسلمين.
وفي هذا الصدد يبقى التسامح أو الاعتراف بالاختلاف هو محور خطاب المؤسسة الدينية الرسمية، ويكاد ينحصر في ثلاث رؤى كما يرى ويشرح رضوان السيد[5]: هى الرؤية المسيحية، والرؤية الإنسانية، والرؤية القرآنية.
أيضا يورد الكتاب عددا من الأمثلة والتٌقارير حول الإسلام السياسي في نظر الغرب : ملخصه أن تركيز الغرب خلال العقود الثلاثة السابقة كان منصباً على الإسلام الشيعي بوصفه الظاهرة الأكثر تهديداً وازعاجاً. أما في الوقت الحاضر فإن التركيز الغربي أصبح منصبُ على النشاط السني، وتدور معظم المخاوف حوله، ويتم النظر إلى النشاط السلفي بشكل خاص على أنه أصولية متزمتة. وقد أكد الاتحاد الأوربي ضرورة الدخول في حوار مع منظمات معارضة إسلامية في الشرق الأوسط للتشجيع على حدوث التحول نحو الديمقراطية. ويبقى سؤال يرد دائما هل سيقبل الإسلاميون في الشرق باستمرار الديمقراطية إذا وصلوا للحكم ؟ يرى وليام غالستون أن تضاؤل حجم العنف باسم الدين في أوروبا ليس بسبب انتصار الأفكار العقلانية؛ بل التجارب التاريخية المريرة هي التي أقنعت الناس بأن الاعتراف بالتعددية الدينية أقل كلفة وضرراً من النزاعات، وأقنعتهم بالتسامح. لذلك تصبح المسألة الأساسية اليوم : هل هناك تطورات داخل الإسلام بفهمه الصحيح يمكن مع الوقت أن تجعل من التعددية أمراً جذاباً وممكناً، حتى بالنسبة للمسلمين التقليديين الذين لا يحبون الليبرالية الغربية ؟!
إن تغير القناعات العامة عند المسلمين بأن القهر باسم الإيمان ينقض نفسهُ بنفسه، وأن الله يمكن الوصول إليه بطرقٍ متعددة، ولذلك لا حق لأحد بفرض السبيل الواحد، إنما الطريق الصحيح هو حرية التنوع في ظل السلم الاجتماعي. أذن لكي تتكون بيئة متسامحة للتعايش ونابذة للعنف والإرهاب لا بد من وجود مرجعيات مؤسسية فوقية للجميع تحفظ حق الاختلاف.
الخلاصة : عند مقاربة موضوع الإرهاب، وحل الإشكالية علينا النظر إلى أبعد من التفسيرات السطحية برد الأمر إلى ظروف اجتماعية أو اقتصادية قاهرة، أو كرد فعل تجاه الإختراق الغربي للمجتمع الإسلامي. إذ يبدو لمؤلف الكتاب أن الأمر بحاجة إلى وضع الأسئلة الصحيحة و(الصعبة في نفس الوقت)، والتي تجاهلتها أدبياتنا لوقت طويل، وهي تمس أساساً البنى الفكرية والدينية للمجتمع الإسلامي، ليس من حيث مساءلة الدين، ولكن من حيث فهمنا للدين وكيف تكونت الفكرة الدينية في سياقها التاريخي. وأرى أنا الذي قمت بتلخيص الكتاب أن هذا الكتاب على الرغم من قلة صفحاته (41 ص) إلا أنه أعتمد على مرجعيات مهمة وقراءات متأنية حول إشكالية مفهوم الإرهاب، الذي بات يشكل هاجساً للأمة الإسلامية ويشكل صعوبة في تولي الرد العملي على الهجمة الغربية. وأرى أن الحل يكمن في الرجوع لقراءة وفهم الإسلام وتاريخه الفهم الصحيح، ونشر المفاهيم الصحيحة للتسامح الديني، الذي هو ديدن الإسلام، خاصة بين شباب الأمة الإسلامية لتحقيق نهضتها وقوتها التي فقدتها، وهي تمثل ربع سكان العالم تقريبا (23%) وتمتد في رقعة جغرافية واسعة، ويعتنق الدين الإسلامي حوالى المليار وستمائة نسمة تقريباً.
* أحمد عبد الكريم سيف هو مدير مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية؛ نائب عميد الكلية اليمنية لدراسات الشرق الأوسط، أستاذ مشارك في العلوم السياسية، جامعة صنعاء