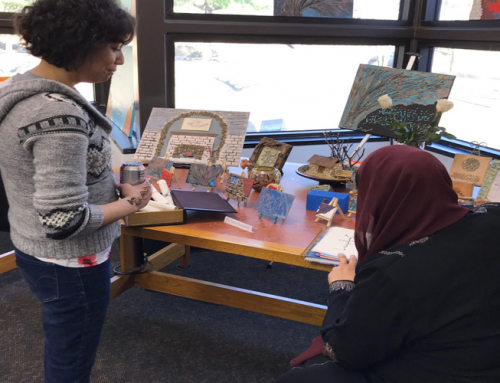إنّ من أشدّ ألوان تحريف القرآن الكريم التي حذّر منها القرآن الكريم إساءة فهمه، فالله تعالى يقول: “فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه” (المائدة/13)، قال إسماعيل بن كثير: “أي: فسدت فهومهم، وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل”، “والمقصود من هذا كما قال محمد الطاهر بن عاشور أن نعتبر بحالهم، ونتعظ من الوقوع في مثلها”، وما الفائدة من إقامة حروف القرآن وإساءة فهمه؟ ومن نافلة القول أنّ الغاية من نزول القرآن العمل به، فعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: “أنزل عليهم القرآن ليعملوا به”، ومن البداهة بمكان أنّ الفهم أساس العمل، فصواب العمل من صواب الفهم، وفساد العمل من فساد الفهم.
وقول الله سبحانه وتعالى: “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين” (الحجرات/9) يُصنّف ضمن “آيات الفتن”، وهذا الصنف من الآيات يُوردها القرآن في سياق التحذير، والإلقاء بها في سياق التبرير لون من ألوان إساءة فهم القرآن الكريم الذي لا يزال يُلقي بظلاله القاتمة على حاضر الأمة ومستقبلها، فوقوع التقاتل بين المسلمين يفرض علينا استدعاء هذه الآية للتحذير لا للتبرير، والخطورة كلّ الخطورة أنّ العقل المسلم يستدعي هذه الآية للتبرير، وتراه يلوك كلّما وقع تقاتل بين المسلمين أنّ القرآن تحدّث عن هذا الأمر، وقد يُمعن في التبرير ويقول: إنّ هذا الأمر وقع في خير القرون بين خير النّاس، وتلك هي مصيبة التبرير لا يدعك حتى يُوقعك في شراك التهوين.
وإذا كانت هذه الآية القرآنية الكريمة وردت في سياق التحذير، فإنّ أهل القرآن لا يفهمون إلا أنها دعوة إلى إيجاد آليات تعصم المجتمع الإسلامي من الوقوع في آفة التقاتل، التي اصطلى المجتمع بنارها منذ فجر الإسلام ولا يزال، “والوجه أن يكون فعل (اقتتلوا) كما قال محمد الطاهر بن عاشور مستعملا في إرادة الوقوع”، فالإسلام يحث المجتمع على “التحرك الوقائي” لا “التحرك العلاجي”، وأسباب النزول الواردة في الصحيحين تبيّن أنّ معنى قول الله تعالى: “اقتتلوا” أي: اختلفوا، والاختلاف يكون كلمة كما يكون رصاصة، وهذه المعاني كلّها مرادة، ويعضد ذلك سبب النزول، فالاقتصار على بعضها دون البعض لون من ألوان تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا ما بيّنه صاحب التحرير والتنوير في (المقدمة التاسعة) “في أنّ المعاني التي تتحمّلها جمل القرآن تعتبر مرادة بها”.
ودعوة القرآن الكريم إلى الإصلاح “دعوة وقائية” لا “دعوة علاجية”، “لأنّ الأمر بالإصلاح بينهما ـ كما قال محمد الطاهر بن عاشور ـ واجب قبل الشروع في الاقتتال، وذلك عند ظهور بوادره، وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال، ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه”، ومن تدبّر قول الله تعالى حقّ التّدبر: “فأصلحوا بينهما” لعلم أنّه دعوة إلى إيجاد فضاءات لحل الخلافات، وخلق آليات لفض النزاعات، وهذا هو “فقه القرآن” الذي يجب أن نلفت إليه الأنظار قصد تفعيله وتنزيله، لأنّ الضمور والقصور أصابه عبر أحقاب متتالية، ولولا خشية اليأس والتشاؤم لقلنا: متى رأى النّور؟ ولو أنصت “الذين آمنوا” إلى قول الحقّ سبحانه وتعالى: “فأصلحوا بينهما”، لعلموا أنّ الله بوأهم “وظيفة سامية”، مما يجعلهم يسارعون إلى امتلاك ناصيتها، بتحصيل شروطها ومؤهلاتها، حتّى يتمكّنوا من أدائها أداء يبرئ الذمة ويحقق المقصد، وإذا تحقق الصلح بزغ شعاع السلم.
والحقّ أنّ هذه الآية القرآنية الكريمة كان يُمكن أن تساهم مساهمة فعّالة في حل الخلافات وفض الصراعات ولكن إخراجها عن سياقها حرم الأمّة من خيرها، فالآية القرآنية: “فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي”، لا تتحدّث عن “البغي” بمعناه الفقهي وإنّما تتحدّث عن “البغي” بمعناه اللغوي، “والبغي ـ كما قال محمد الطاهر بن عاشور ـ الظلم والاعتداء على حق الغير، وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي، وهو غير معناه الفقهي، فـ(التي تبغي) هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحقّ وإن لم تقاتل، لأنّ بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقّها”، والأمم الحية تسعى إلى إيجاد آليات لمنع البغي، وإحداث نظم لتجفيف منابعه، وأما الأمم الأخرى فمبلغ جهدها مطاردة البغاة وملاحقتهم، وشتّان شتّان بين أمّة تقطع رأس الأفعى وأمّة تقطع ذنبها، والخطوة الأولى في تجفيف منابع البغي هي إرساء دعائم العدل، أمّا وأنّ العدل قد جفّت أنهاره ولهذا نرى أنّ البغي قد هاجت بحاره.
والقرآن الكريم يقوم على أولوية الوقاية على العلاج، وضمن هذه الرؤية القرآنية يجب أن نفهم قول الله تعالى: “فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله”، فالقتال لا يُراد لذاته وإنما هو وسيلة لترجع الفئة الباغية إلى أمر الله، “فـ(التي تبغي) ـ كما قال صاحب التحرير والتنوير ـ هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحقّ وإن لم تقاتل”، فالبغي لا يعني بالضرورة حمل السلاح، وهذا يعني أنّ قتال التي تبغي لا يعني بالضرورة أن يكون بالسلاح، وإنما يكون بكلّ وسيلة تلبي الغاية وتحقق المقصد، ويجعل التي تبغي ترجع إلى أمر الله، لأنّ “قتال السلاح” لا يجعل التي تبغي تفئ إلى أمر الله، وإنما يجعلها تؤجل المعركة ريثما تؤول كفّة القوة إلى صالحها، وحركة التاريخ تقول إنّ الاحتكام إلى السلاح لا يحل مشكلة، ولا يعالج أزمة، وإراقة الدماء لا تولّد إلا إراقة الدماء، ويدخل المجتمع في مسلسل من الثارات لا ينتهي، وسلسلة من الأحقاد لا تتوقف يرثها الخلف عن السلف والأبناء عن الآباء، ولهذا فإنّ “قتال السلاح” يكون ـ إن كان ـ “عملية جراحية موضعية” بعد استنفاد كلّ الوسائل والسبل، وبناء على قرارات مدروسة، وتأملات متأنية، من باب ارتكاب أخفّ الضررين.
وإذا بانت هذه الحقائق عرف المرء لماذا ذيّل الله تعالى هذه الآية القرآنية الكريمة بقوله: “فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين”، فرجوع الفئة الباغية إلى أمر الله ليس هو خاتمة المطاف، وإنما خاتمة المطاف “فأصلحوا بينهما بالعدل”، لأنّ الله تعالى الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان يعلم أنّ “الشعور بالمغلوبية” لا يؤدي إلا إلى كسر الخواطر، وشحن الأفئدة بالإحن، وملء الصدور بالثارات، ولا يُفكّك هذه القنابل الموقوتة إلا “فأصلحوا بينهما بالعدل” الذي تشعر فيه كلّ طائفة أنّها استردّت حقوقها، واسترجعت كرامتها، فتخرج سليمة الصدر، نقية السريرة، وتلكم هي الخطوة الأولى في طريق بناء المجتمع المثالي، الذي يحرسه “وأقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين”.
والقرآن الكريم يخبرنا أنّ المؤمنين إخوة، ولم يطلب من المؤمنين أن يكونوا إخوة، قال الله تعالى: “إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون” (الحجرات/10)، فهذه الآية جاءت في صيغة الجملة الخبرية لتقرّر أمرا مفروغا منه، ولم تأت في صيغة الجملة الإنشائية لتأمر المؤمنين بالإخاء فيما بينهم، وعقد الأخوة من عقد الإيمان، وأيّ ثلمة في عقد الأخوة هي ثلمة في عقد الإيمان، فلا يتصوّر أن تحدث مشاقة بين طائفتين من المؤمنين وإيمانهم بخير، فإذا وقعت مشاقة بين طائفتين من المؤمنين فالبدار البدار إلى تفقّد إيمانهم، فإذا استقام إيمانهم استقامت أخوتهم، وإذا اختل إيمانهم اختلت أخوتهم، ولهذا فإنّ حرص القرآن الكريم على ترميم عقد الأخوة هو في الحقيقة حرص على ترميم عقد الإيمان، ولو فهم المسلمون هذه الحقيقة القرآنية لما وقعت مشاقة بينهم، وإن وقعت كانوا أحرص النّاس على ردم الهوة وإصلاح الفجوة، ولكن أقاموا واديا بين عقد الأخوة وعقد الإيمان فكان أن وقعت الكارثة، ولو تتبعنا الحقوق التي يجب الوفاء بها لعقد الإيمان وعقد الأخوة لوجدنا أنّ هناك أكثر من تطابق بينهما، فالإخلال بعقد الأخوة إخلال بعقد الإيمان، والإخلال بعقد الإيمان إخلال بعقد الأخوة، فمتى تستوعب أمّة القرآن هذه المعادلة القرآنية؟
أحمد رشيق بكيني
رئيس المركز الثقافي الإسلامي ـ سطيف ـ الجزائر