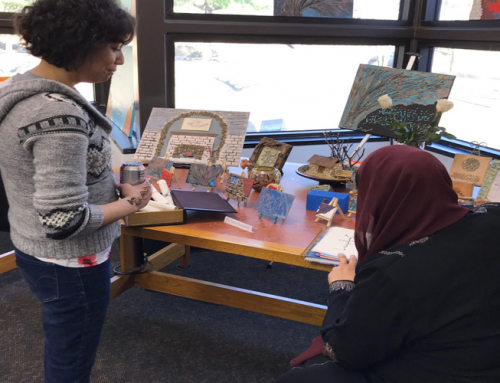في ظل الهجمات التي استيقظت على هولها باريس وبيروت ومالي، وسلسلة الأحداث التي باتت العراق وسوريا وبلدان منطقة الساحل الأفريقي نَهْباً لها، أضحى القضاء على آفة الإرهاب ودَفْع شرِّها أولويةً قصوى لدى المجتمع الدولي. على أن حل هذه المعضلة يكمن بدايةً في فهم مُسبِّبات الظاهرة فهماً واضحاً. ولقد اضطلَعت منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة دولية سياسية تضم في عضويتها 57 دولة، على مدى 40 عاماً من تأسيسها، بدور طلائعي في الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب على الصعيد الدولي. فقد كانت المنظمة سباقةً إلى الإقرار بخطورة ظاهرة الإرهاب والتنبيه إلى ضرورة التصدي لها، فكان من ثمرة جهودها الحثيثة والمتواصلة في هذا المجال مدونةُ قواعد السلوك بشأن محاربة الإرهاب الدولي واتفاقيةُ منظمة التعاون الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي اللتين أقرَّتهما المنظمة في عامي 1994 و1999 على التوالي.
ولقد انطلقت منظمة التعاون الإسلامي في جهودها لمحاربة الإرهاب من البحث في جذور هذه الظاهرة، من خلال تقصي السياق السياسي، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والبيئة الثقافية والمرجعية الإيديولوجية التي أفرزتها. فنحن في منظمة التعاون الإسلامي لا نحصي الدين والمعتقد الديني ضمن محركات الإرهاب، وإنما نعتقد بأنهما يُوظَّفان للتحريض عليه. وتشاطرُ منظمةَ التعاون الإسلامي هذه الرؤية التي تَشكَّلت معالمُها في العديد من البيانات الصادرة عنها، منظماتٌ مماثلة وحكوماتُ دولٍ عديدة. والحال أن الجهود الحالية لقطع دابر المجموعات والتنظيمات الإرهابية مثل داعش – وهو التعبير المختصر الأكثر مَذمَّةً في اللغة العربية لاسم التنظيم “دولة الإسلام في العراق والشام” – تَقتصِر بشكلٍ كبيرٍ على الأعمال العسكرية، اللّهمَّ ما كان من بعض أشكال الدعم الإنساني محدودة النطاق.
أما الالتزامُ بإيجاد حلول سياسية واقتصادية وثقافية للظاهرة مِن الواقع فما هو إلا مقامُ الحبر من الورق لم يَتجاوَز لحظة سَكْبِه. فلا تكون وسيلتنا إلى إنجاح جهود مواجهة التطرف العدواني والإرهاب سوى الإقرارُ بهذا الأمر.
ففي الوضع العراقي الحالي ما يدلُّ على أن للتعصب الطائفي جذور سياسية. فقد تفككت مؤسسات الدولة ودواوينها وأجهزة الأمن والجيش وحزب البعث على أيدي حكام العراق منذ لحظة اجتياحه عام 2003. ومما زاد الوضع سوءاً خطابُ التفرقة الذي أدى إلى استفحال حالة الشقاق الطائفي والعرقي بين مكونات الشعب العراقي. فما عاد يُنظر إلى أهل العراق على أنهم أبناء الوطن نفسه، بل استحالوا شيعةً وسنةً وأكراداً وعرباً. فالعراق ابتُلي بمخطط تهميش وتفرقة حِيك له منذ أن تسلَّط عليه الاحتلال.
وفي محافظة درعا في سوريا، ردَّ جهاز الأمن التابع للرئيس الأسد بالقمع الشديد على مَطلَبٍ سلميٍّ للأهالي بالتخفيف من أساليب الإكراه والتعسف التي ينتهجها النظام ضدهم. آنئذ لم يكن لداعش أو جبهة النصرة وجودٌ في سوريا. إلاَّ أن موقف السكون الذي اتخذه المجتمع الدولي إزاء ما ألمَّ بسوريا من غَصْبٍ على أيدي القوات العسكرية للنظام السوري أفضى إلى بروز أفكار ومواقف رجعية متطرفة.
فما الذي نقوم به لمعالجة هذه الأوضاع السياسية التي عجَّلت بتصاعد وتيرة التطرف المصحوب بالعنف الذي يتهددنا جميعاً؟ وما مدى نجاح الجهود التي نبذلها لبناء المؤسسات في العراق؟ وهل يمكن التحرك على مسار عملية سياسية بقيادة سوريا من دون خارطة طريق سياسية ومؤسسية؟ وإذا كنا نرغب في تدارك إخفاقاتنا في العراق، أيمكننا بحق أن نتخيل نجاح أية عملية سياسية في سوريا لا يشارك فيها جميع السوريين على اختلاف أطيافهم المجتمعية والسياسية؟
ثم هاكم مثالاً آخر على ارتباط استحكام التطرف العنيف بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تفرزه. فيكفي أن يتجول المرءُ في شوارع مدينة ماديغوري، عاصمة ولاية بورنو، شمالي نيجيريا، ليرى كيف يَهيمُ الشبابُ على وجوههم حشوداً في الشوارع المهترئة لا تكاد أعيُنُهم تبصر للأمل بصيصاً ولا يستقيمون إلى هدف بعينه. فلا جرَمَ أن هذه الظروف رَمَت بهؤلاء إلى الانضواء تحت لواء المتطرفين، يدفعهم إلى ذلك حلم جني المال وتحقيق الذات. فقد غدا هذا الجزء من نيجيريا، ومعه منطقة الساحل الأفريقي وشمال مالي والصومال، بؤرةً ومرتعاً للتنظيمات المتطرفة تَنتشرُ فيه وتتغلغل. فهؤلاء الشباب في حاجة إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية وإيجاد مشاريع تتيح فرص العمل للجميع سبيلاً لتطوير المهارات وتوفير الدخل وتخليص النفوس والعقول من اليأس والقنوط. فهل يا ترى بَذَلْنا ما يلزم من الوقت والموارد لتصحيح هذه الأوضاع، في سعينا المشترك للقضاء على التطرف المصحوب بالعنف؟
فلكي نقضي على التطرف العنيف، لا مَعْدِل عن محاربة الإيديولوجيات والمرجعيات الفكرية للحركات التي تَدَّعي زيفاً انتسابها للإسلام. ويعني هذا ضرورة نشر رسالة الإسلام التي قوامها المساواة وعمادها العدل وجوهرها روح المسؤولية الفردية والحرية. ويجب من ثم تعزيز منظومة الأخلاق الإسلامية وإشاعتها، فلا ينبغي أن تبلغ بنا الغفلة حدًّا يُنسينا بأن المسلمين يشكلون ربع الإنسانية وبأن صرح الحضارة الإسلامية سامقَ في الماضي سائرَ الحضارات في شتى فروع المعارف.
ولا بد لنا أن نعي بأن البلدان والقوى التي لديها مصالح في مناطق النزاع قد تغير من أجنداتها السياسية الخاصة. كما ينبغي أن ندرك بأن الوقت قد حان لكي يستفيق المثقف المسلم من غفلته وأن يسلك سبيل الحداثة يما يوافق مقومات ديننا الإسلامي.
ثم إننا لن نخلص بأعمالنا إلى شيء، ما لم ندرك بأن القمع والاضطهاد يُنتِجان الفكر المتطرف والراديكالي. وعلى سبيل المثال، فإن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون، في ظل غياب الإرادة السياسية لديه لصد حكومة إسرائيل عن خرق مبادئ القانون الدولي، سيظل سبباً في انقياد الشباب المتحمس وراء الأفكار المتطرفة وانحيازه إلى العنف سبيلاً لتغيير عالم يغيب عنه العدل والإنصاف. على أنه ومع ضرورة التركيز على الحلول العسكرية، لا بد لنا من التحلي بالجرأة اللاَّزمة لطرح الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح، وتقصي الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الإرهاب. فلا سبيل غير هذا لتحصين العالم من داعش والفكر الذي تحمله.
وختاماً، لا ينبغي أن ننسى أن مثل هذه التنظيمات في افترائها على الإسلام باتخاذه مطيةً لإضفاء الشرعية على ما تقترفه من أفعال بشعة، تُشابِه غيرها من مظاهر التعبير عن الإرهاب التي تُنسب لثقافات وديانات أخرى.